شباب مغربي بلا أفق أم أفق بدون استماع؟
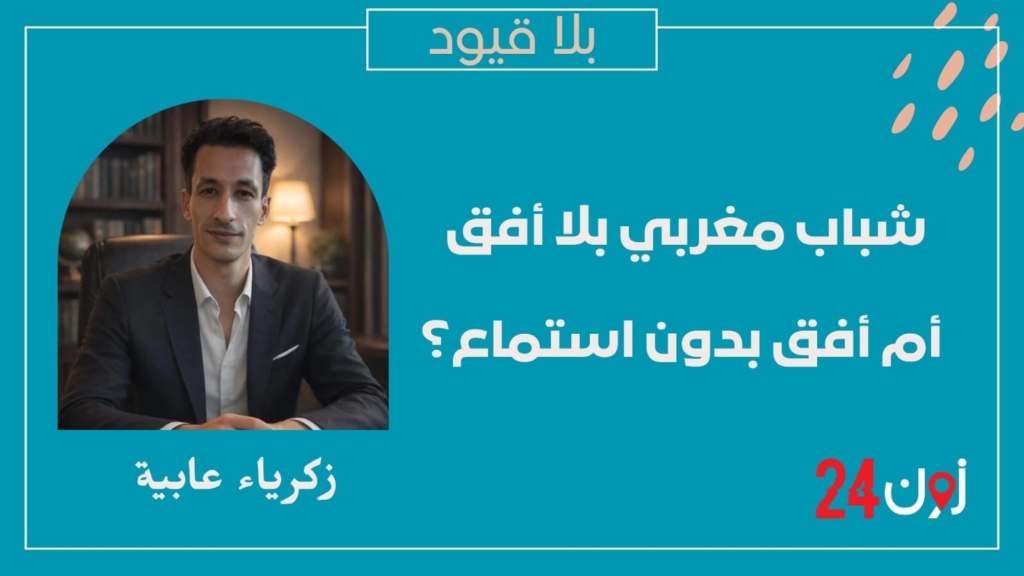
يُكتب لكل صبيٍّ منا أن يترعرع في بيئة تجعل منه، فجأة، مغربيًا بالحتمية، ثم يحاول هذا الفرد جاهدًا أن يُجسِّد مغربيته بالانتماء، وبطريقة التعايش، وبالامتثال للتقاليد والأعراف… التي تبني هويته شيئًا فشيئًا. خلال مرحلة الصبا، يتسع خيالنا لمجرة، ونشعر بأن الحلم والخيال حقٌّ مشروع، دونما حاجة إلى أن يُنتزع. نشكّك، ونتساءل، ونختار ما يريحنا… لكن سرعان ما ندخل مرحلة “الشباب” حتى نجد أحلامنا قد اختفت، وفضولنا العلمي قد تبخّر، وتشكيكنا قد قُمِع. نجد أنفسنا فجأة أمام أصابع الاتهام، أصابع موجّهة من كل جهة: من العائلة، والمدرسة، والمجتمع، تتّهمنا بالفشل، وتطالبنا بالنجاح وفق معايير لم نستعد لها، وقد رُسِمت مسبقًا. أصابع لم ترحم، وأنتجت لنا عبارة “الشباب المغربي” كشماعة يُعلّقون عليها خطاياهم، حيث وجه المجتمع هو عينه وجه الشباب المغربي، وحال المجتمع هو حال الشباب المغربي. هذا الأخير الذي قُدِّمت له مسؤولية ضخمة، يحاول جاهدًا أن يرفعها على ظهره، ويدفعها نحو الأعلى كما يدفع سيزيف صخرته. صخرة لم يستعد لها ظهر الشاب، حتى أصبح أنينه من الألم حالة مشتركة؛ فقط البعض يصرخ معبّرًا عنها، والآخر يتحمّلها صامتًا.
لقد تحوّل ألم المسؤولية إلى إحباط قُسِم على الجميع، حتى أصبح يعبّر عن حالة شبه عامة، إحباط يعكس هول تطلعات لنجاح في واقع لم يُصمَّم أصلًا ليمنحنا فرصًا حقيقية!
فهل الشباب المغربي حقًا قد فشل، وأصبح يُعتبَر بلا أفق؟ أم أنه اجتهد وصرخ، بينما لم يجد لصراخه مؤسسات الدولة كآذانٍ صاغية؟
لفهم ما يحصل،وجب النظر إلى تكوين الشاب المغربي كمراحل ، و ليس كمفهوم منفصل ، فلو اقتربنا بعدسة مجهرنا أكثر ، و قمنا بفحص ما يقع، و حاولنا الإصغاء إلى هذا الإحباط بعيدًا عن الاتهام، لبدَا كأنه نتيجة مسار طويل متأثر (تربية ، تعليم، مؤسسات..)، لا كحادثة مفاجئة فقط. مسار يبدأ من فضاءات كان يُفترض أن تُحتضن فيها الأسئلة، لكنها تحوّلت، مع الوقت، إلى أماكن تقدس الإجابات ، و تهوى التدجين. هناك، يتعلّم الشاب مبكرًا أن الطريق الآمن هو الطريق المرسوم سلفًا، وأن التفكير ترف و عبء لا ضرورة له. يكبر وهو يراكم و يبتلع معارف لا يعرف كيف يستخدمها، وشهادات لا تفتح له سوى أبواب البطالة. وفي البيت، لا يُربّى على خوض التجربة بقدر ما يُربّى على تجنّب الخطأ، فيصير الحذر المفرط أسلوب حياة. وحين يصل إلى لحظة الاصطدام بالواقع، يُطلب منه أن يتحمّل النتائج كاملة، بينما تختفي الأصابع التي صاغت الشروط الأولى وراء خشبة المشهد. يُسأل عن تعثّره، ولا يُسأل السياق المُلام، ويُلام الفرد حيث كان يفترض أن تُراجَع الخيارات. أما الفضاء العام، الذي كان من الممكن أن يتحوّل إلى مجال إنصات وحوار، فقد اكتفى بدور المتفرّج، يستدعي الشباب عند الحاجة إلى الشعارات، ثم يعيدهم إلى الهامش عند لحظة القرار. هكذا يتكوّن الإحباط، لا كضعف ذاتي، بل كإحساس عميق باللاجدوى، إحساس يولد حين يُطالَب المرء بالنجاح داخل لعبة لم يُسمَح له يومًا بتعلّم قواعدها.
لعلّ الإشكال، في النهاية، ليس في الشباب بقدر ما هو في الطريقة التي نراه بها ونخاطبه من خلالها. فالشباب ليس مرحلة عابرة ولا مشكلة ظرفية، بل مرآة دقيقة لما نزرعه في التعليم، ونكرّسه في التربية، ونتجاهله في السياسة. وحين نُصرّ على مساءلته وحده، فإننا في الواقع نتهرّب من مساءلة أنفسنا. فالشباب المغربي لم يفقد الأفق فجأة، بل أُطفئت معالمه بالتدريج، وسط خطاب يطالبه بالنجاح دون أن يعترف بثمنه. وربما آن الأوان للانتقال من لغة الاتهام إلى لغة الفهم، ومن الرغبة في إصدار الأحكام إلى الجرأة على الإصغاء، لأن مجتمعًا لا يسمع شبابه إنما يؤجّل فقط لحظة سماع خبر احتضاره و جنازته.



